28مايو
النّاضورة
في ليالٍ كَتَمَت سرَّ الهَوى
بالدُّجى لولا شُموس الغُرَرِ
مَالَ نجمُ الكأسِ فيها وهَوَى
مُستقيمَ السَيرِ سَعدَ الآثَرِ
حينَ لذّ النومُ شيئًا أو كَمَا
هَجَمَ الصُّبحُ هجومَ الحَرَسِ
غارَتِ الشُّهبُ بنا أو رُبَّما
أَثَّرَت فينا عيونُ النَّرجِسِ
هنا مكثتُ يومين، ولم تكن الصحراءُ حانيةً؛ بل كانت أشدُّ وطئًا، وكان قلبي أقومَ قيلًا.
لا أعرفُ لماذا استجبتُ إلى دعوةِ “تمّام” حينما طلبَ منّي أن أقتصَّ يومينِ من أفرعِ حياتي المتشابكة؛ لأقضيهما برفقتهِ في حضرةِ الصَّحراء، تردَّدتُ في بادئِ الأمر، فأنا حياتي صفراءُ تسرُّ الناظرين، أكوامُ رمالٍ وصخورٍ تمتدُ على مرمى نظري في الجهاتِ الأربعة، اللهم إن كانت تلكَ النَّبتةُ الخضراءِ التي كانت تؤنسُ وحشتي أثناءَ الطريق، أفتحُ عيني على ملامحها الطفولية وأغلقهما عليها، بينما تفيضُ من وجهها ابتسامةٌ تحيلُ الشقاءَ من حولي جنَّةً لم يسكنها سواي.
قلتُ في خاطري: كُل الأماكنِ في غيابِ تلكَ النَّبتةِ صحراءُ قاسية، لم ألمح من حولي فيها إلا السراب، وأنا لا أجيدُ الرَّكضَ خلفَ غياباتِ الوهم.
عاتبتُ النَّبتةَ همسًا في سريرتي؛ لأنّي لم أكن أقوى على ذلكَ في الواقع، أنا أراها كطفلةٍ لا يمكنها إفلاتَ يدي، حتى وإن أظهرت عكس ما في داخلي.
حزمتُ حقيبةَ ظهري بعد أن حصلتَ على جوازِ سفري، وكعادتي حجزتُ على متنِ أوّل طائرة متجهةٍ إلى ذلكَ المطار، حيثُ تمرُّ الطائرة أثناء هبوطها التدريجي قريبًا من أجواءِ بلدتها، أما عيناي فأراهما شاخصتين في التفاصيلِ الصغيرة حيثُ تبدو الأرضُ كما لو كانت لم تدهسها قَدم من قبل.
تمنّيتُ لو أغمضُ عيني أثناءَ الرحلةِ؛ فلا يتراءى أمامي شيء سوى ملامحها، تلكَ البيضاءُ التي يُشبهُ وجهُها اكتمالَ البدر، ولكنَّ حظيَ التعيسُ دائمًا ما يلاحقني، حتى وأنا عالقٌ ما بينَ السَّماءِ والأرض.
دامت الرحلةُ ساعتين ونصف الساعة حتّى لامست عجلاتُ الطائرةِ أرضَ المطار، لكنّي أحسستُ أنَّ الرحلةَ تتجاوزُ أعوامي الثلاثة والثلاثين، أيامٌ مرَّت وأحداثٌ جَرَت، خيالاتٌ تعبرُ أمامي، يكفي تلكَ الكوابيس التي تطاردني دائمًا، والتي أصبحت تلتهمني منذُ أن وقعَ ذلك الغيابُ اللعين، حتى أني تخيَّلتُ ملامحَكِ في وجهِ تلكَ المضيفةِ التي يمتلئُ وجهها قليلًا، أحسستُ وكأنها أنتِ بكل تفاصيلك التي أحفظها عن ظهرِ قلب، انتفضتُ بكُل عنفواني من مقعدي؛ كي أسألكِ كيفَ جئتِ إلى هُنا دونَ عِلمي، ولكنّي تفاجأتُ بحزامِ الأمانِ يكادُ يشطرُني إلى نصفين؛ لقد كادت تلكَ القطعةُ المعدنية تخترقُ أسفلَ بَطني، جلستُ والألمُ يعتصرني، كتمتُ صرخةً اتضحت آثارها في وجهي الذي كاد ينضحُ دمًا، ثمَّ رفعتُ رأسي؛ لأنظرَ نحوَ ذلكَ الصوتِ الذي يسألني:
-هل أنتَ بخير؟
كانت المضيفةُ التي تشبهُكِ _أو كما تخيَّلتُ_ تسألني إن كنتُ في حاجةٍ إلى مساعدةٍ طبّية، أخبرتها أني على ما يُرام، لكنّها اتجهت نحو مطبخِ الطائرة الأمامي، ثم عادت بعد لحظات وهي تحمل حبّتين من البروفين، ثم لم تتردّد عن فتحِ الطاولة التي أمامي؛ كي تضعهما فوقها وبجوارهما زجاجةَ ماءٍ معدنية، ثمَّ ابتسمت قائلةً:
-تَحت أي ظَرف تقدر تاخد حبّاية لحد ما نوصل.
لماذا يتحدَّثونَ دائمًا عن ذلكَ الألم المادي؟ نعم أصابتني القطعة المعدنية إصابةً قاتلة، لازلتُ أعاني منها حتى كتابتي لهذه الأحداث، ولكنّها لم تكن أبدًا بتلكَ القسوة التي تؤجّجُها نيرانُ آلامٍ أخرى.
لو تعلمُ المضيفةُ سببَ آلامي التي لا توقفها مسكّناتُ العالمِ، لأحضرتكِ لي بدلًا عن البروفين.
عدتُ برأسي للوراء متجاهلًا صراخَ طفلٍ يجلسُ في المقعد الخلفي، ومتجاهلًا حديثَ اثنين يجلسانِ بجواري، أغضمتُ عيني ولم يكن في الظلامِ أمامي سوى ملامحكِ التي كُنتُ أتبيّنُ وهجهما في العتمة، لماذا أبدو بذلكَ الضعف؟!
أذكرُ أنّي أستطيعُ احتمالَ الكثير، فلماذا لا يُمكنني احتمالَ غيابك؟!
أسلمتُ نَفسي إلى الخيالاتِ التي تتراءى أمامي، حينها استعدتُ ابتساماتك، انفعالاتك، وجومَكِ حينما نغضبُ قليلًا، حتى حينما تغمضينَ عينَيكِ قليلًا، وأنت تُقرّبين سبَّابَتكِ الرقيقةَ نحو فمِكِ، وتقولين:
-أنا.. أنا.. أنا.
لماذا يا إلهي كل هذه القسوة؟!
للمرةِ الأولى التي أغمضُ فيها عيناي دون أن تراودني الكوابيسُ المُميتة، أبحرتُ بقاربِ النّجاةِ في تلكَ العتمةِ نحوَ ملامحك، كدتُ أقتربُ لولا ذلكَ المضيفُ الذي كان يهرولُ في الممرِ بينَ المقاعدِ، وهو يطلبُ من الرّكاب ربطَ الأحزمة، لو يعرفُ الأبلهُ أنَّ حزامَ أماني كما هو، وأنّي لم أستطع وضع يدي فوقَ تلكَ المنطقة التي لازال يعتصرها الألم لما أوقفَ قاربي المُبحر.
غادرتُ الطائرةَ حاملًا حقيبتي فوقَ ظَهري، مُمسكًا بجوازِ سَفري استعدادًا لتوثيقِ دخولي إلى مصر، كانَ المطارُ غير مزدحمٍ؛ لذلكَ أنهيتُ إجراءاتِ وصولي في وقتٍ قياسيٍّ، ثمَّ خرجتُ من صالةِ المطارِ باحثًا عن “تمّام” الذي أخبرني أنه سيكون بانتظاري، وما إن التَقط هاتفي إشعارًا بأنه تمَّ تفعيله كتجوالٍ حتى استلمتُ رسالةً عرفتُ منها أنه ينتظرني في كافيتيريا المطار، على الفورِ اتجهتُ إلى حيث أخبرني في رسالته..
جلستُ برفقتهِ، احتسيتُ فنجانَ قهوةٍ كُنت بحاجةٍ إليه، ثم أخبرني أن أخاه الأكبرَ ينتظرنا داخل سيارته، على الفورِ قُمنا، كانت السيارةُ في مكانٍ قريبٍ من الكافتيريا، صافحني أخوه كما لو أنه يعرفني منذُ عُمرٍ طويل، حتى أنه أصرَّ أن أجلسَ في المِقعدِ الأمامي!
بعدَ ساعاتٍ من السيرِ راودني هواءُ الطريقِ عن حُلمٍ فَنمتُ، صافحتُ ملامحَها مرةً أخرى، كان وجهها أقربُ إلى تيوليبةٍ بيضاءَ تشوبها بعضُ الحُمرةُ، عيناها كشمسين تشرقانِ في آنٍ واحد، أما أنا فكنتُ عاجزًا عن التحديقِ فيهما، كانت تقفُ في ظلِّ شجرةٍ وافرةَ الظلِّ، اقتربتُ منها كما لو كنتُ أقتربُ من سِدرةِ العشقِ الذي يسكُنني، رهبةٌ تشطرُ قلبي إلى نصفين بمجردِ أن وقفتُ في حضرتِها بعدَ هذا الغيابِ الطويل، حاولتُ أن أمدَّ يدي؛ كي أقطفَ تلكَ التّفاحةَ المحرّمة التي نضجت في خدّيها، شعرتُ حينها برجفةٍ عنيفةٍ استيقظتُ على إثرها، كانت السيارةُ ترتجُّ بشدة، فتحتُ عيني وقد كانت الدنيا ظلامًا، لكنّي استطعتُ أن أسمع صوتَ “تمّام”، وهو يقول:
-ذلك الذي على يمينكَ هو معبدُ النّاضورة.
لم أكُن أرى شيئًا، كان كُل شيء باهتاً في ناظري إلا ملامحها التي ترسّخت في مخيّلتي، لذلك أومأتُ برأسي فيما معناهُ أني أرى ما يشيرُ إليه، ولكنّي كُنت قد أصِبتُ بالعَمى، فلم أستَطع إبصارَ شيءٍ سواها.
***
بالذي أسكَرَ من عَزمِ الَّلمَى
كلُّ عَزمٍ تحتسيهِ وحَبَبْ
والذي كَحَّلَ جفنيكَ بِمَا
سَجَدَ السِّحرُ لديهِ واقتَرَبْ
والذي أجرى دموعي عندما
عندما أعرَضتَ من غيرِ سَبَبْ
ضَع على صدريَ يُمناكَ فما
أجدرَ الماءَ بإطفاءِ اللهَبْ
البيتُ مُريحٌ، مساحةٌ فسيحةٌ من طابقٍ واحد، تُحيطُ بها أشجارٌ لم أعرفُ اسمَها، لكنها ليست شاهقةَ الطولِ.
دخلتُ برفقةِ “تمّام” بعد أنا غادرنا أخوه إلى بيتٍ آخر يسكُن فيهِ برفقةِ زوجته، جلستُ في غُرفةٍ أعادتني إلى بلدتِنا القديمةِ القابعةِ في أريافِ المنصورة، حوائطُ البيت السميكةُ جعلتِ الهواءَ رطبًا ومُنعِشًا، حينها قال لي “تمّام”:
-لا أريدُ منكَ البقاءَ في غرفةِ الضيوف، لقد أعددتُ غرفةً خاصةً لك.
لكنّي لم أكُن أرغبُ إلا في الجلوسِ هُنا، فقلتُ:
-إن بقائي هُنا يُشعرُني براحةٍ أكثر من أي مكانٍ آخر.
بعدَ قليلٍ وجدتهُ يدخل إلى الغرفةَ وهو يحملُ الأَنجَرَ، وكما أخبرني عنه مُسبقًا أنه طبقٌ كبيرٌ من الصاج، لكنّي استعجبتُ مما يحتويه ذلكَ الطبقُ، فقلتُ:
-فتّةٌ في الليل؟!
ثمَّ وضعَ الأنجرَ فوقَ الأريكةِ أمامي، وقال:
-هي عادتنا، نتناولها في الغَداء، وربّما نُكرمُ بها ضيوفَنا متى وفدوا إلينا.
أكلتُ حتّى لا أُشعرهُ بحرجٍ، رغم إني لم أعتدِ تناولَ الطعامِ في الليل، ثمَّ جلسنا مَعًا، لم يتحدّث مُطلقًا عن العَمل، لكنه كان ينسجُ الحكاياتِ حولَ الواحةِ، حتى شعرتُ برأسي يتثاقلُ، حينها أنهى ما يقصّه عليَّ، وتركَني بعدَ أن أخبرني أنه سوفَ يصحَبُني في نُزهةٍ بَعدَ الفَجر.
تمددتُ فوقَ الأريكةِ وكنتُ بحاجةٍ إلى غِطاء، رُبما لم يكُن الأمرُ يستحقُّ ولكنّه ضَعفٌ شعرتُ بهِ في جسدي أصابني برعشةٍ مفاجئة، بحثتُ في الغرفةِ فوجدتُ بطّانيةً خشنة، تذكرتُ بمجردِ أن لمستها أيامَ المُعسكرات، وأدركتُ أنه رغمَ خشونتها إلا أنها قادرةٌ على قطعِ دابرِ البَردِ من الجِسد.
بعد أن شعرتُ بالدفءِ غادرتني الرغبةُ في النوم، لقد نسيتُ أن العقلَ لا بدَ أن ينامَ أولًا حتى يمنحَ الجسدَ تذكرةَ الدخولِ إلى أرضِ السُّبات، هواجسٌ تتصارعُ بداخلي، وذلكَ السؤال اللحوح الذي لم يغادرني: لماذا غادرَتني فجأةً؟!
رُبما كان ما حدثَ خطأ غير مقصودٍ منّي، قدّمتُ على إثرهِ قرابينَ الاعتذارِ وأكاليلَ التأسّف، وربما لم أكن أملكُ من الحيطةِ والحذرِ ما يمنع حدوثَ مثلِ ذلك الخطأ، أنا أتعاملُ بتلقائيةِ طفلٍ، كل ما أعرفه أني أحبُها فقط، هي تُشبِهُني كما لو أننا خُلِقنا من قطعةِ طينٍ واحدة، حتّى ظروفنا مُتشابهة تمامًا، ما إن صارَحتني حتى بُحتُ بكلِّ شيءٍ أخبّئهُ بداخلي، الآنَ تقتربُ تارةً وتبتعدُ أخرى، تُصافيني في الليلِ وتُجافيني في النهار، وتُصاحبني في النّهار وتهجُرني في الليل، إن ذلكَ يحدثُ بعد أن كُنا نتشاركُ أدقَّ تفاصيلِنا، أحلامِنا، خوفنا، ابتساماتنا الصادقة، أكثر ما باتَ يُحزِنُني أنها تُكذّبني، وددتُ لو أصرخُ فيها؛ لأخبرها أنها مخطئة، هناكَ فقط شيءٌ لا أعرفه يجعلها لم تعد تستطيع قراءَتي، حتى في الآونةِ الأخيرة أخبرتني أني اختيارها الذي جاءَ كما لم تكُن تتمنّى، هي لو تُفكِرُ قليلًا؛ لعلمَت أن الشَّخصَ الخاطئَ لن يجيءَ إليها من آخر بقاعِ الدُّنيا مهرولًا، فقط كي يراها للمرةِ الأولى.
لا أعرفُ كيفَ سقطتُ في بئر عميقةٍ من النوم، لكنّي استيقظتُ على يد “تمّام” التي كانت تهزّ كتفي برفقٍ:
-استيقِظ، سوفَ نذهبُ إلى مكانٍ قريب، هناكَ رجلٌ أرغبُ في أن تتقابَل معه.
تحاملتُ على نفسي وقمتُ، رغمَ أني كُنت أشعرُ بلذّةٍ في النومِ لم أرَ مثيلتها منذ زمنٍ طويل، حتّى أنّي نِمتُ بملابسِ السّفرِ ولم يمنَحني التفكيرُ مُهلةً؛ كي أستبدلَها.
خرجنا من البيتِ، الصحراءُ هنا لم تختلف عن تلكَ التي أقبعُ فيها كثيرًا، كثبانٌ رمليةٌ وحَصَى، مشينا حتى ابتعدنا عن بيوتِ القرية، كان يحدّثني عن كل شيء نمرُّ أمامه، أما أنا فلم أهتم بكل ذلك، بل شغل تفكيري ذلكَ الرجلُ الذي نحنُ بصددِ الذهابِ إليه.
بعدَ وقتٍ من السير، وصلنا منطقةً ترعى فيها الماشية، أرضٌ مليئةٌ بالعُشبِ الصحراوي بها خيمتان، اقتربنا فنفَرَتِ الماشيةٌ خوفًا، حتى بلغنا خيمةً يجلسُ أمامَها رجلٌ عجوز، ما إن رآنا حتى قال:
-اقتَرب يا “تمّام” يا ولدي.
اقترَبَ واقتربتُ معَه، ثمَّ قالَ لي:
-الشّيخ “دُرغام” بَركةُ النّاضورة، أعدُكَ أنّك ستخرجُ من مجلسِهِ كيومِ ولدتكَ أمُّك.
جلسنا بينما كان أمامَه برّادُ شايٍ يتصاعدُ منه البُخارُ فوقَ راكيةٍ بها أخشابٌ تتوهّج، ثمَّ قالَ الشّيخ:
-يا “تمّام”، قدّم الشّايَ إلى الضيف.
لقد اقشعرَّ جسدي بمجردِ أن ارتشفتُ أوّلَ رشفةٍ من الكوب، حتّى أنّي وجدتُ “تمّام” يضحكُ بصوتٍ مُرتفعٍ، وهو يقول:
-أعرفُ أنّكَ لا تُحبُّ السُّكر، لكنّها عادةُ الشيخ “درغام”.
لم أستطع أن أخالفَ هَيبةَ ذلك الشيخ الذي شعرتُ براحةٍ حينما نظرتُ إلى ملامحهِ فجذّبَتني تجاعيده، كم خبرة يحملها ذلك الرجلُ الذي أصابته الأيامُ بكلِّ هذه النتوء، وكأنه أرادَ أن يشغلني عن طعمِ السُّكر اللاذعِ الذي بدا أثرُه على وجهي، فبادرني بالحديث:
-بابُ الإنسانِ وجهه، ونافذتهُ عيناه، هكذا علّمتنا الأيامَ كيفَ ندخلُ إلى نفسِ من نتحدّث؛ لذلك أخبرني، هل تحبّها؟
لقد شعرتُ برشفةِ الشاي، وهي عالقةٌ في حلقي لا تريدُ أن تتزحزح، لكنّي ابتلعتُ ريقي، وقلت:
-عن أي شيء تتحدّث يا شيخ؟
-لا تجادل يا ولدي، طيفُها يلوحُ في عينيك، هل يمكن أن تعكسُ المرآة صورةَ شيءٍ غير موجود؟ العينُ مرآةُ القلب، إنها تعكسُ ما في قلبِكَ، أنا أراها، هي بيضاءُ وكأنّها سحابةُ صيفٍ تمنحُكَ الظّل.
في الحقيقةِ جاهدتُ كي أتمالكَ أعصابي، لقد شعرتُ لوهلةٍ أنَّ الشيخَ يراها رأيَ العينِ ويتغزّلُ بها، حتّى أنّه لاحظَ فورانَ الدّم في عروقِ رقبتي، فقال:
-لا تغضب هكذا، ليس بينَ البصيرةِ والحبِّ حجابٌ، إنها تستطيع أن ترى ما لا تراه أعيننا.
حينها غادرنا “تمّام”، لا أعرفُ إلى أي مكان قد ذهب، ولكنّي توقّعتُ أنه يمنحني فرصةً كي أتحدّثَ بحرّية؛ لذلك قلتُ للشيخ:
-أحبّتني حبَّ الجنون، تشابَهنا إلى حدٍّ كبير، كانت القشّةَ التي أمسكتُ بها بينما كان يجرفُني تيّارٌ عنيف، أنقذَتني من غَرقٍ مُحتّمٍ، ومن قاعٍ مُظلمٍ كِدتُ أسقطُ فيه، لقد غيّرتني، كانت حياتي مُظلمة، تروّعني رنّةُ هاتفٍ، ثمَّ جاءَت فانتَزَعتِ الخوفَ من داخلي، جعلتني أواجهُ الدُّنيا، حتّى أني واجهتُ الجميعَ بها..
أنا أيضًا كنتُ لها قشّةٌ أمسَكت بها؛ كي تنجو من غَرقٍ مُحتّم، ألم أخبرك أننا نتشابهُ حدَّ التطابق؟ تعاهدنا على أن نبدأ من جديدٍ، نغلق كل ما مضى، لكنها فجأةً أصبحت تراني بصورةٍ ما كنت يومًا عليها، حتّى أني أعدتُ تفكيري مراراً، أتساءلُ كثيرًا هل فشلتُ في احتوائِها؟ أنا أفعلُ كلَّ شيءٍ لإرضائها، حتّى إن أخطأت أقولُ لها: لا عليكِ، حتّى أنها قالت ذاتَ مرةٍ لا تُشعرني بأنّك قطعةُ ثلجٍ، إذا أغضبتُكَ فأفرغ غضبَكَ في وجهي، لا تُشعرني بأنكَ لا تَهتمَ بي، وما كانَ مني في كل مرةٍ أسمع فيها تلكَ الكلماتِ إلا أن أبتسم؛ لأخبرها بأنّي إذا ماكان باستطاعتي أن أجعلها تبتسمُ، فإني أرحّبُ بالموتِ قبل أن أجعلها تشعرُ بخوفٍ منّي، أنا لا أنكرُ أنّي لا أتمالكُ نفسي في بعضِ الوقت، ولكن حينما أشعرُ بالغيرةِ تجاهها، لكن ذلك ليس بإرادتي، هي مهدّدةٌ بالضياعِ منّي، لظروفٍ لا أرغبُ في الحديثِ عنها، أنا لا أستطيعُ النومَ، ما إن أغمضُ عيني حتى تبتلعني الكوابيس، هناكَ يدٌ تحاولُ انتزاعها منّي، بينما هي تمدُّ يدها نحوي؛ لألحقَ بها، لقد حاولتُ أن أجعلها تستوعبَ هذا الأمر، لكنّها كانت تعي ما أقول، والآنَ تفعلُ أشياءَ لا أعرفُ لها تفسيرًا، كانت تبكي خوفًا من أن أتركها بعد أن عثرت عليَّ، الآنَ هي التي تبتعد، إنها تغادرني تدريجيًّا، ولا تعلمُ أن روحي سوفَ تغادرني أيضًا إذا غادرتني.
لقد أشارَ لي الشيخُ بيدهِ فتوقّفتُ عن الحديث، حينها قال:
-يا ولدي انقلابُ الأمورِ المفاجئِ هكذا ليسَ طبيعيًا أبدًا، هناكَ غِشاوةٌ وُضِعَت على العين، حينها يرى الإنسانُ منّا القُبحَ في الأشياء الجميلة التي يمتلكها، أنا أراها الآن في عينيكَ باكيةً، خائفةً، تودُّ لو أنَّ بينها وبينكَ أمدًا قريبًا، تتمنى لو أنّك تأخذها من يديها، وتسيرُ بها إلى آخر بقاعِ الأرض، لكنّ ثمّة قيدٍ يكبّلها، ابحث عن ذلك القيد يا ولدي!
وكأنّي فَطنتُ إلى ما يشيرُ إليه الشيخ، لكنّ “تمّام” لم يمنحنا فرصةً للحديث، لقد عاد بعد وقتٍ من التجوالِ، وهو يقول:
-أتمنى لو أنَّ جلوسك هنا منحكَ بعضَ الهدوء.
قلتُ ولم أكن أكذب:
-هذه حقيقةٌ لا أستطيعُ أن أُنكرَها.
أكملتُ كوبَ الشايِ عن طيبِ خاطرٍ، وكأنّي أشكرُ الشيخَ على تلك السكينةِ التي غلَّفت قلبي، ثم تناولنا الغداءَ، للمرةِ الثانية التي أرى فيها الأنجرَ الذي يمتلأ بالفتّة، أكلتُ كما لو أنّي جائعٌ منذ أمدٍ بعيد، ثمَّ جلسنا، بينما يحكي الشيخُ عن الواحةِ، لقد عرفتُ مؤخّرًا أن عمرَهُ يتجاوزُ التسعينَ عامًا، عرفتُ حينها أن ما يحملهُ وجهه يعكسُ زمنًا طويلًا من الحكمة.
انقضى اليومُ، لم أشعر بمللٍ قط، لكنّي كُنت أشعرُ بطيفِها من حولي، وبصوتِها الذي كان ينطقُ اسمي دائمًا بدُعابةٍ اشتقتُ إليها، حتى أظلمَ المكانُ من حولِنا، حينها بدتِ السماءُ وكأنها سماءً سافيرية، تلمعُ النجومُ فيها وكأنَّ تلكَ البقعة من الأرض تقتربُ من السماءِ دونًا عن أي مكانٍ آخر، حينها فقط كانت ركايا النار تشتعلُ من حولِنا.
نِمتُ في الخيمةِ المجاورةِ لخيمةِ الشيخ، كانت شاغرةً ليسَ بها أحد، يومها لم تراودني الكوابيسُ، فقط كان حُلمًا سأحتفظُ بتفاصيلهِ لنفسي، ربما أقصّه عليها وحدَها في يومٍ ما..
في الصباح، أحضرَ “تمّام” السيارة، ثم أخبرني أن أخاه لن يستطيع اصطحابي إلى بلدتي؛ لارتباطهِ بعملٍ ضروري، وأن هناك سائقًا سوفَ يصطحبني إلى هناك.
صاحفتُ الشيخَ قبل أن أغادرَ، حتّى أني وعدتهُ بزيارةٍ أخرى إن منحنا القدرُ فرصةً قادمة، ثمَّ صافحني “تمّام” بحرارةٍ، وقال:
-سوفَ ألقاكَ هناك، أتمنى لو أن تلك الزيارة قد خفّفت عنكَ قليلًا.
جلستُ بجوارِ السائق الذي تعرفتُ عليه، سوفَ يرافقني لساعاتٍ طويلةٍ في الطريق، وما إن تحرّكتِ السيارة حتى قال لي:
-وقتٌ طويلٌ حتى نصلُ إلى القاهرة، ومنها إلى…
قاطعتُه مُنزعجًا، وقلت:
-أريدُ أن نذهبَ عبرَ الطريقِ الساحلي، من هنا إلى مطروح مرورًا بالإسكندرية حتى نصل.
قضيتُ الوقتَ وأنا أقتلهُ بالحديثِ مع السائق، كان بشوشَ الوجهِ طيّبًا، حتى أني لم أشعر بساعاتِ الطريقِ الطويلة، وصلنا إلى مطروح بعد ساعاتٍ طويلة، ثم بعد ساعاتٍ أخرى تجاوزنا الإسكندرية، وفي ذلك المكان طلبتُ من السائقِ أن يقف، كانت لافتةُ مدينتها على يمينِ الطريقِ، تأملتُها كثيرًا، كدتُ أخبرُ السائقَ أن يوصلني إلى مدينتها ويفلِتُني هناك، وأنا سوفَ أكملُ إليها ولو سيرًا، فأنا أحفظُ الطريقَ إليها أكثر من طريقِ بيتي، ولكنّي تذكرتُ آخرَ حديثٍ بيننا، خشيتُ أن تفرَّ منّي مرةً أخرى، أصابني فزعٌ خوفَ أن تتسعَ الفجوةُ أكثر، حينها أخبرتُ السائقَ أن يُكملَ طريقَه، فأنا أشعر أن لقاءَنا لم يحن بعد.
يا أُهَيلَ الحَيِّ من وادي الغَضَا
وبقَلبي مَسكنُ أنتُم بهِ
ضَاقَ عن وجدي بِكم رَحبُ الفَضَا
لا أُبالي شرقَهُ من غَربِهِ
أَحوَرُ المُقلَةِ مَعسولُ اللمَى
جَالَ في النَّفسِ مَجالَ النَّفَسِ
سدَّدَ السَّهمَ فأصمَى إذ رَمَى
بفؤادِي نَبلَةَ المُفتَرِسِ

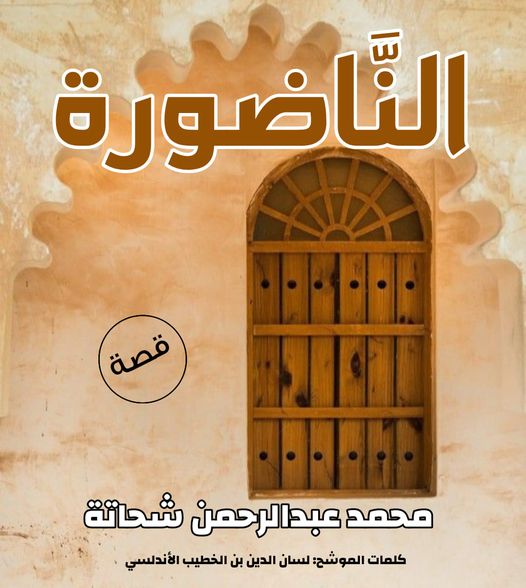







اترك تعليقاً